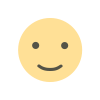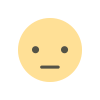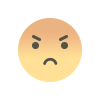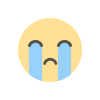التردد ليس حيادًا: لماذا يصبح عدم اتخاذ القرار هو القرار الأخطر؟
حين يصبح التردد سلوكًا مألوفًا، لا لأن الخيارات معقدة، بل لأن الذات خائفة من مسؤولية الحسم، نفقد القدرة على الحركة ونختبئ خلف قرارات مؤجلة. هذا المقال يتناول ظاهرة "عدم اتخاذ القرار" من منظور نفسي واجتماعي، ويقترح علاجًا يبدأ من الداخل، عبر ترميم القيم، وتحرير الإرادة، واستعادة السيادة الذاتية.

حين يصبح التردد موقفًا: تحليل نفسي لسلوك "عدم اتخاذ القرار"
الجزء الأول: الخوف المقنّع وانهيار الذات أمام مرآة التزييف
في عمق كل لحظة تردد، يوجد قرار خفي. قرار بعدم التحرك. قرار بأن نبقى في منطقة رمادية، لا نُقدِم فيها على خطوة جديدة، ولا نعود بالكامل إلى ما كنا عليه. وكأننا نرفض أن نُولد مرة أخرى، لكننا لا نريد أن نموت أيضًا. هذا التجمّد، الذي يبدو في ظاهره حيادًا، هو في حقيقته أكثر الأفعال تطرفًا في مواجهة الحياة.
لنفهم هذا السلوك لا يكفي أن نقول إنه "خوف من الخطأ"، بل ينبغي أن نغوص في بنية هذا الخوف: ما الذي نخافه فعلاً حين نُدعى لاتخاذ قرار؟ الفشل؟ اللوم؟ انكشاف حقيقتنا؟ أم انهيار الصورة اللامعة التي بنيناها لأنفسنا أمام الناس – وأمام أنفسنا أولاً؟
الخبرة المصنوعة والهوية الموهومة
أحد أكثر الأسباب عمقًا وراء التردد هو التناقض بين ما نظنه عن أنفسنا وما نحن عليه فعلاً. فالبعض يصنع لنفسه صورة خبير، قائد، مستشار، ثم حين يوضع أمام قرار حقيقي، يُفترض فيه أن يُثبت جدارته – يتلعثم. لا لأنه لا يعرف، بل لأنه لم يتدرّب على الفعل، بل فقط على إقناع الآخرين بأنه يعرف.
حين نُمنح المكانة دون أن نمر بتجربة الصعود الحقيقي – وعبر ألم التعلم – فإننا نرتدي قناعًا هشًا لا يصمد أمام أول اختبار فعلي. هنا يتجلّى التردد لا كخوف فقط، بل كفضيحة داخلية. لأن القرار في هذه الحالة لا يهدد النتائج فقط، بل يهدد الهوية التي ادعيناها.
المال الذي جاء بلا عرق، والمنصب الذي جاء بلا تعب
النجاحات السريعة، المكافآت التي لا تقابلها خبرة، الألقاب التي تُمنح في سير ذاتية أنيقة… كل هذه العناصر تصنع نسخة متضخمة من الذات، لكنها نسخة غير قابلة للتنفيذ. ومع الوقت، يُصبح صاحبها أسيرًا لصورته. فهو لا يملك حرية التراجع، ولا شجاعة التقدّم، ولا مساحة للاعتراف: "لا أعرف".
ولهذا، فإن التردد غالبًا ليس ناتجًا عن نقص في المعلومات، بل عن فجوة داخلية بين الصورة التي نروّجها عن أنفسنا، والحقيقة التي نحاول إخفاءها.
الخوف كقناع ناعم: "أنا فقط أحتاج مزيدًا من الوقت"
كم مرة استخدمنا هذه العبارة؟ كم مرة خبّأنا خلفها هشاشتنا، أو افتقارنا للثقة، أو إدراكنا الداخلي أننا غير مستعدين رغم كل مظاهر الاستعداد؟ أحيانًا، يكون القرار هو تأجيل القرار، لأن الحسم يتطلب مسؤولية لا نملكها بعد، ويعرّينا من عباءة "التفكير" التي نلجأ إليها حين نخاف من المواجهة.
المفارقة الكبرى أن التردد – رغم كونه تراجعًا – يستهلك طاقة أكبر من القرار نفسه. يقتل الوقت، يسرق الفرص، وينهك النفس. لكننا نمارسه لأنه أكثر أمانًا من الفعل… أو هكذا نظن.
القرار المؤجل هو قرار مخفي
هنا تتجلّى الفكرة الأخطر: عدم اتخاذ القرار، هو بحد ذاته قرار. لكنه قرارٌ خفي، غير معلن، لا نتحمّل مسؤوليته، ولا نعترف به علنًا. هو شكل من أشكال الانسحاب التكتيكي الذي نستخدمه حين لا نريد الاعتراف بأننا لا نعرف ماذا نفعل.
لكن الحياة لا تتوقف لتنتظرنا، بل تُمرّر القرارات إلى غيرنا، وتُحمّلنا تكلفة اللا قرار، بشكل أو بآخر.
حين يصبح التردد نمط حياة: تحليل اجتماعي لسلوك "عدم اتخاذ القرار"
الجزء الثاني: هندسة التردد اجتماعيًا... حين تصنع البيئة ذاتًا تخاف من الحسم
في مجتمعاتنا الحديثة، لا يُولد الإنسان مترددًا، بل يُعاد تشكيله هكذا. تُربّى قراراته على التجميد، وتُدرّب نفسه على المراوغة، وتُكافأ قدراته في التمثيل أكثر من قدراته في الإنجاز. التردد، إذًا، ليس ضعفًا داخليًا فقط، بل صناعة اجتماعية ممنهجة، تبدأ من الطفولة، وتتضخم مع المديح، وتنتهي بإنسان يعرف كل شيء… إلا كيف يختار.
تربية الطاووس: حين نُضخم الطفل فنقتل وعيه بذاته
كم من مرة سمعنا عبارات من نوع: "ابني عبقري"، "بنتي تفهم كل شيء"، "ولدي أحسن من دكتور الجامعة نفسه!"… التربية في بيئتنا العربية – وربما الشرقية عمومًا – تميل إلى تصنيع وهم التفوق المبكر. لا نُدرّب أبناءنا على الجهد، بل نُغرقهم بالمديح، لا على ما أنجزوا، بل على ما نتخيله عنهم. فنخلق ذاتًا لا ترى في الخطأ تجربة، بل إهانة. ولا في القرار مسؤولية، بل خطرًا على صورة الكمال المزيفة التي تمّ بناؤها منذ الطفولة.
طفل كُبر وهو يُقال له إنه "ذكي"، لا يعرف لاحقًا كيف يعترف أنه لا يملك إجابة. وطفلة اعتادت أن تُقال لها "الأولى دائمًا"، لا تملك المساحة لأن تكون مترددة، أو متأخرة، أو باحثة.
وهنا يولد التردد: ليس لأنه لا يعرف، بل لأنه لا يُسمح له بأن لا يعرف.
البيئة التي تهتم بالصوت، وتتغاضى عن الفعل
نعيش في مجتمع تُقاس فيه القيمة بالصوت لا بالفعل. فكلما ارتفع صوتك، وازداد حضورك على المنصات، كلما بدا أنك أكثر كفاءة. لا أحد يسألك: "ماذا نفذت؟"، بل: "كم متابعًا تملك؟"، و"كم مرة ظهرت؟"، و"من استشهد بك؟".
تُكافأ الخطابات، لا الإنجازات. يُحتفى بالتصريحات، لا بالأثر. ولهذا، يتعلّم الفرد أن الصوت هو الوسيلة الأسرع لبناء مكانة، حتى إن لم تكن تملك شيئًا حقيقيا. وفي لحظة اتخاذ قرار، لا تسعفك الأصوات، بل أفعالك… وهنا يحدث الانكشاف.
الفرار المقنع: حين نختبئ خلف "دراسة القرار" بدلًا من اتخاذه
من أكثر أشكال التردد حداثة هو ما يُسمى بـ"الفرار المُقنن": أن تُخفي عجزك عن الحسم تحت غطاء مهذب من العبارات الذكية. كأن تقول:
-
"نحتاج دراسة إضافية."
-
"أفضّل مشاورة الخبراء أولًا."
-
"فلنُجمّد القرار حتى تتضح الصورة أكثر."
هذه الجُمل لا تُشير دائمًا إلى حكمة، بل أحيانًا إلى تهرّب ناعم من اتخاذ موقف. لأن الحسم يعني أنك ستكون مسؤولًا، والمجتمع ربّاك على تفادي المسؤولية أكثر من امتلاكها. ولهذا، نُطيل مرحلة "التحليل"، حتى تفقد القرارات معناها، والفرص توقيتها، والحياة اتجاهها.
المجتمع الذي يمدح الخطابة، وينسى الإنجاز
في الثقافة السائدة، يُكافأ من يتحدث جيدًا أكثر ممن يعمل بصمت. يُحتفى بمن يصمم العروض التقديمية بشكل رنان، أكثر ممن يحوّل الأفكار إلى واقع. وفي هذا الإطار، يصبح التردد سلوكًا منطقيًا: لأن المجتمع نفسه لا يُحاسب على النتائج، بل يُبهر بالشكل.
بل حتى في المؤسسات، تُعلّق الترقية على "الحضور"، و"القدرة على الإقناع"، لا على الإنتاجية أو حُسن اتخاذ القرار. وهكذا ينشأ التردد لا كضعف، بل كتكيف مع ثقافة لا ترى في القرار بطولة، بل مخاطرة غير مأمونة.
الربط بين البيئة والنفس: حين يُعاد برمجة الخوف على هيئة حكمة
المفارقة هنا أن الفرد المتردد لا يرى نفسه كذلك. بل يراه "متأنيًا"، "عميقًا"، "راشدًا"، وقد يمتدح تردده باعتباره حذرًا ناضجًا، في حين أنه انعكاس لخوف اجتماعي طويل الأمد، تمّت برمجته منذ الطفولة على تفادي الحسم، لأن الحسم يعني: أن تُرى كما أنت، لا كما تُظهر نفسك.
تحرير القرار: حين تستعيد الذات سيادتها من قبضة التردد
الجزء الثالث: معالجة التردد من الداخل… وبناء ذات تقرّر بوعي لا بردّة فعل
بعد أن كشفنا في الجزأين السابقين البُعدين النفسي والاجتماعي لسلوك "عدم اتخاذ القرار"، ننتقل الآن إلى مساحة المعالجة، حيث لا تكفي "النوايا الحسنة" لتصحيح مسار الذات، بل نحتاج إلى إعادة بناء الداخل وفق منظومة قيم واضحة، تعيد للإنسان بوصلته، وتمنحه الجرأة على الحسم، حتى حين تكون العواقب غير مضمونة.
أول خطوة في الشفاء: الاعتراف بأن التردد ليس حكمة بل ضعف في التكوين
الخطوة الأكثر أهمية – والأكثر إيلامًا – في تجاوز التردد هي الاعتراف بأننا في أحيان كثيرة لا نُحسن اتخاذ القرار ليس لأن الخيارات صعبة، بل لأن ذواتنا غير مجهزة لتحمل ما يلي القرار أو عواقبه. نؤجل لا لأن المسألة معقدة، بل لأننا لا نحتمل احتمالية أن نكون مخطئين، أو أن نُحاسب، أو أن نظهر على غير الصورة التي رسمناها عن أنفسنا.
ولهذا، فإن العلاج لا يبدأ بالبحث عن القرار "الصحيح"، بل ببناء ذات تتحمل الخطأ، وتتعامل معه بكرامة لا بانكسار.
القيم الذاتية: البوصلة التي لا تخذلك حين تتداخل الأصوات
في قلب كل شخصية حاسمة، توجد منظومة قيم واضحة وغير قابلة للتفاوض. القيم ليست شعارات، بل خرائط داخلية تُبسّط المعقد، وتوجّه صاحبها في لحظات الغموض. من دون هذه القيم، يكون القرار إما استجابة لخوف، أو إرضاءً للآخرين، أو هروبًا من موقف.
من أهم القيم التي تصنع شخصية قادرة على الحسم:
-
الوضوح الذاتي: أن تعرف من أنت وماذا تريد، بعيدًا عن تصفيق الناس أو لومهم.
-
المسؤولية: أن تؤمن بأن كل قرار تتخذه هو انعكاس لسيادتك، وليس ذريعة تلوم بها الظروف.
-
الاحترام للوقت: لأن التردد يسرق العمر بصمت. والقرار، حتى إن لم يكن الأفضل، هو بداية الحركة.
-
النزاهة مع الذات: ألا تتخذ القرار لتُرضي أحدًا أو لتتجنب صدامًا، بل لأنك تراه صوابك، حتى لو خالف الإجماع.
-
الاستقلالية: أن تفصل بين "صوتك" و"صوتهم"، وتعرف متى يكون رأي الآخرين تشويشًا لا مشورة.
علامات الشخصية الحاسمة: من أين تعرف أنك تملك "نواة القرار"؟
ليست كل شخصية حاسمة صاخبة. بعضهم يتخذ قراراته في صمت، لكن بثبات. وهذه بعض العلامات التي تشير إلى تكوّن شخصية قادرة على الحسم:
-
لا تُطيل الوقوف عند كل مفترق طريق: تدرك أن التردد استنزاف، وأن القرار – حتى الخاطئ – أفضل من الجمود.
-
تتقبل العواقب دون تبرير: لا تُحمّل الآخرين نتائج خياراتك، بل تتعلم، وتتطور.
-
لا تحتاج دائمًا إلى تصفيق: تقرر لأنك مقتنع، لا لأنك تريد أن تُعجب أحدًا.
-
تملك قدرة على التراجع: لا ترى الخطأ نهاية، بل درسًا يعيد ضبط المسار.
-
تسأل السؤال الأصعب قبل القرار: "ما الذي سأخسره لو لم أقرّر؟"
القرار بوصفه تمرينًا مستمرًا لا لحظة فاصلة
الحسم لا يُبنى في قرار واحد، بل في سلسلة طويلة من المواقف الصغيرة، التي تُراكم الثقة بالذات. كل مرة تقرر فيها – أن تقول لا، أن تنسحب، أن تختار طريقًا لم يصفق له أحد – فإنك تبني عضلة داخلية اسمها: "أنا أستطيع أن أتحمّل قراراتي".
ولهذا، فإن القرار ليس قفزة، بل تدريب. والذات الحاسمة لا تُولد، بل تُنحت.
من التردد إلى السيادة
التردد ليس "عجزًا فكريًا"، بل تآكل تدريجي في بنيتك النفسية والاجتماعية والقيَمية. والخلاص منه لا يكون باتخاذ قرار واحد ضخم، بل بصناعة بيئة داخلية لا تخاف من القرار، بل تحترمه، وتؤمن أن الخطأ أرحم من الجمود، وأن الفعل، حتى إن خالف التوقعات، أنبل من الصمت المتواطئ.